ارتبط مفهوم السفسطة بالحركة السوفسطائية وهي حركة فكرية واجتماعية نشأت وترعرعت في اليونان القديمة خلال القرن الخامس قبل الميلاد ورفعت شعار "الإنسان مقياس كل شيء"، ودافعت عن نسبية الحقيقة وارتباطها بالظروف المتغيرة، فانتهت إلى التأكيد على أهمية اللجوء للحيل الخطابية والألاعيب القولية لتحقيق المصالح الشخصية، وعلى رأسها التأييد الجماهيري في المعارك السياسية التي كانت أثينا مسرحا لها خلال هذه الفترة. ولم يكتف السوفسطائيون بممارسة السفسطة وحدهم، بل تمكنوا من إقناع صفوة المجتمع آنذاك بضرورة تلقي دروس في هذا المجال إن كانوا يرغبون في تحقيق مصالح اجتماعية وسياسية واقتصادية، فتمكنوا بفضل ذلك من جمع ثروات عظيمة.
التفلسف هي كلمة مشتقة من الفلسفة و فعلها تفلسف على وزن تفعلل, و هذا الوزن يدل على المطاولة في الفعل المجرد “فلسف”, أي أكثر في الفلسفة. و لقد تغير استخدامها في سورية في العصر الحديث لتحصل على معنى آخر جديد, فأصبحت تستخدم في وصف الكلام المنطقي الغير مفهوم أو المفحم, فأصبحت تقول للشخص إذا أفحمك “مفلسف” أو “متفلسف”, و بذلك فالتفلسف يعني الكلام المنطقي المفحم, و هو كذلك مصدر الفعل تفلسف.
كما هو معروف ولا يختلف عليه إثنان (عاقلان ومفكران)، أن الفلسفة علم عريق وقديم قِدَم الزمان من سقراط إلى يومنا هذا، وما درجة Ph.D. التي تُمنح في الجامعات الغربية حالياً إلا معناها "دكتور في الفلسفة". ولكنه خطير أيضاً إن لم يُتعمّق فيه ويُتروّى، كما قال أحد العلماء ناصحاً تلميذه: "إن الفلسفة بحر، على خلاف البحور، يجد راكبه الخطر والزيغ في سواحله وشطآنه، والأمان والإيمان في لججه وأعماقه".
وهناك بعض من (محدودي العلم والتفكير والثقافة) من خلطوا بين الفلسفة والسفسطة. فعندما يسمعون كلاماً منطقياً لا يعجبهم نظراً لمحدودية تفكيرهم فإنهم يقولون: "لا تتفلسف" أو يغلطون حتى في النطق فيقول بعض الجهلاء: "لا تتفلفس".
وإليكم معنى "السفسطة" كما ورد ذكرها في كتاب "قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن" للشيخ نديم الجسر – مفتي طرابلس. وهذا الكتاب قرّظه كثير من العلماء والأدباء والحكام ورؤساء دول عندما طُبع ونُشر عام 1961م:
"من كلمة السوفسطائية جاءت السفسطة. فالسوفسطائية هي طريقة الجماعة، الذين برعوا في تعليم الناس قلب الحقائق، بالجدل الكاذب. وإسمهم هذا من كلمة (سوفيست)، وهي تدل في اليونانية على المعلم، من أي فرع من الصناعات والعلوم. ثم صارت تطلق على هؤلاء المعلمين؛ ومنها نحَتَ العرب كلمة (سفسطة). وليس للسوفسطائيين مذهب فلسفي معلوم، ولا آراء تربطها روح الفلسفة، التي تبحث عن الحق، ولكنهم جماعة من المعلمين ظهروا في بلاد اليونان، في ظروف إجتماعية، كانت نطغى فيها على البلاد موجة من الشك والكفر بآلهة الأساطير، وموجة من الديمقراطية فتحت للناس أبواب المناصب، من طريق التلاعب بالجماهير؛ فمهروا في تعليم الناس فنون البيان، والخطابة، والجدل، وتزويق الكلام. وكانوا يفخرون بأنهم يستطيعون أن يؤيّدوا الرأي ونقيضه، وتمادوا في غوايتهم، حتى كانت طريقتهم تؤدي إلى هدم أسس العقل والمعرفة، وتمزيق الأخلاق.
وأشهرهم (بروتاغوراس)، واضع المحور الذي تدور عليه سخافات السوفسطائيين، بقوله المشهور: (إن الإنسان مقياس كل شيء)؛ فقد كان العلماء والفلاسفة يرون أن الحقيقة تُدرَك بالعقل لا بالحس؛ لأن الحواس خادعة، فجاء بروتاغوراس هذا، ينكر المعرفة بالعقل، ويزعم أن الإحساس هو المصدر الوحيد للمعرفة. ولما كان الناس يختلفون باحساساتهم، باختلاف أجسادهم، وأعمارهم، فقد أصبح إدراك الحقيقة مستحيلاً، وأصبح ما يدركه كل شخص صحيحاً بالنسبة إليه، ولا يوجد شيء يمكن أن يسمّى خطأ، لأن كل رأي هو صحيح بالنسبة للشخص المدرِك ... وقد أطلق العرب على هذا المبدأ القائل بأن الإنسان مقياس كل شيء، إسم (العِـنـديـّة)، لأنه يؤدي لاعتقاد كل فردٍ بما عنده.
ثم جاء أحدهم، (غورجياس)، فدفع السوفسطائية إلى غايتها الأخيرة في السخافة والهذيان والتعطيل، حين أنكر، دفعة واحدة، وجود الأشياء. وقال باستحالة المعرفة، والتعارف والتفاهم بين الناس. ونحن نرى أن هذا الهذيان أضعف وأهون من أن يدخل في مباحث الفلسفة، وإن كان له الفضل من حيث أنه أخرج لنا سقراط. إن سقراط هو الذي أسس وبنى فلسفة المعرفة، التي لا تزال تسيطر على العقول السليمة، منذ أكثر من ألفي سنة إلى اليوم الذي نحن فيه، مهما اختلف الجدل حولها. وما كان لسقراط في الفلسفة من غرض إلا أن يضع قواعد المعرفة على أساس العقل، ويوطد دعائم (الفضيلة) في صدور الناس، على أساس من الحق الذي لاريب فيه. فقد رأى هذا الفيلسوف، أن أخلاق عصره تنهار أمام دجل السوفسطائيين الذين أنكروا العقل، والحق، واليقين، وفضائل الأخلاق، بما زعموا من ردّ أصول المعرفة كلها إلى الإحساس؛ فأراد أن يرد أصول المعرفة إلى العقل، الذي يتفق الناس جميعاً على أحكامه بلا خلاف، ليصل بهذا إلى وضع حدٍّ وتعريفٍ للفضيلة.
يقول سقراط: لا يعقل أن تكون المعرفة مبنية على الحواس، لأن الحواس تختلف باختلاف الأفراد والظروف والأحوال، فعلينا أن نتلمس أصلاً ثابتاً للمعرفة، لا يختلف فيه الناس أبداً. وإذا نظرنا إلى معارفنا، رأينا أنها تنطوي على إدراكات جزئية، تأتينا من طريق الحواس، وعلى إدراكات كلية عامة ليس لها وجود في الخارج ليمكن الإحساس بها. وضرب على ذلك مثلاً معنى (النوع) الذي تدركه عقولنا، بجمع الصفات التي يشترك بها كل أفراد النوع، وطرح الصفات العارضة التي تظهر في بعض أفراده؛ فقال أن هذا الإدراك، لشيءٍ لا يُحَس، ولا وجود له في الخارج، هو إدراك كلي، لا يرتاب عاقل في كونه من عمل العقل وحده. وهذا الإدراك الكلي العقلي، هو الذي يجب أن تؤسس عليه المعرفة. فإذا كانت المدركات الحسية الجزئية تختلف باختلاف الأفراد والظروف والأحوال والأوضاع، فإن العقل الذي هو عام ومشترك بين الناس، لا يختلف ما دام سليماً. ونحن، بهذه الإدراكات العقلية الكلية، نستطيع أن نضع لكل شيء حداً وتعريفاً، ونستطيع بهذا، أن نضع مقاييس صحيحة ثابتة للحقائق، ونعرف ما هي الفضيلة.
وجاء بعد بعد سقراط، تلميذه (أفلاطون) الشهير، فأيّد نظرية المعرفة التي وضعها أستاذه، وزادها توطيداً. ولكن لا ندري لماذا وضع هذه المعرفة على أساس (المُـثُـل) وأي شيء يقصد بالمثل؟
انه يقول: ان المعاني الكلية ليست مما يمكن إدراكه بالحواس، وإنما يكون إدراكها بالعقل وحده؛ فالجمال والقبح مثلاً، هما معنيان ندركهما في أشياء كثيرة مختلفة في مظاهرها وأشكالها؛ فما الذي عرّفنا أن هذه الأشياء تشترك في الجمال، وهذه تشترك في القبح؟ ليست حواسنا هي المدركة لهذا الإشتراك، بل هي عقولنا، التي تقابل وتقارن بين الأشياء المشتركة في الجمال، فتدرك أن فيها جمالاً. ولكن لكي تَـقْـدر عقولنا على هذه المقابلة والمقارنة، لا بد أن تكون لديها فكرة أصيلة سابقة عن الجمال والقبح. ولو قلنا أن هذه الفكرة من اختراع عقولنا ، لرجعنا القهقرى إلى السوفسطائية، التي تقيس الحقائق بمقياس شخصي فردي محض. فلا بد لنا إذنْ أن نقول أن هذه المعاني الكلية لها وجود حقيقي وراء عقولنا؛ وهذه هي التي أطلق عليها أفلاطون إسم (المثل les idees). وقال ان نفوسنا، قبل حلولها في الأجسام، كانت تعيش في عالم المُـثـُل، فلما حلت في الأجسام، نسيت عالم المثل، بعض النسيان، ولكن اذا وقع نظرها على معنى كلي، كالجمال والقبح، تذكرتْ مثاله، فأدركت بالمقارنة، ما في الأشياء من جمال أو قبح. وهكذا الحال في كل المعاني الكلية كالفضيلة والعدل والخير وغير ذلك. فالعلم هو تذكّر للمثل، والجهل نسيان لها. وما التجارب في الحياة الدنيا، إلا وسيلة لتنبيه العقول وتذكيرها بما عرفته من قبل، في عالم المُـثُـلْ ...
منقول ومقتبس بتصرف بسيط من كتاب: قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ نديم الجسر – مفتي طرابلس.
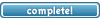



 Bookmarks
Bookmarks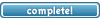



 Bookmarks
Bookmarks